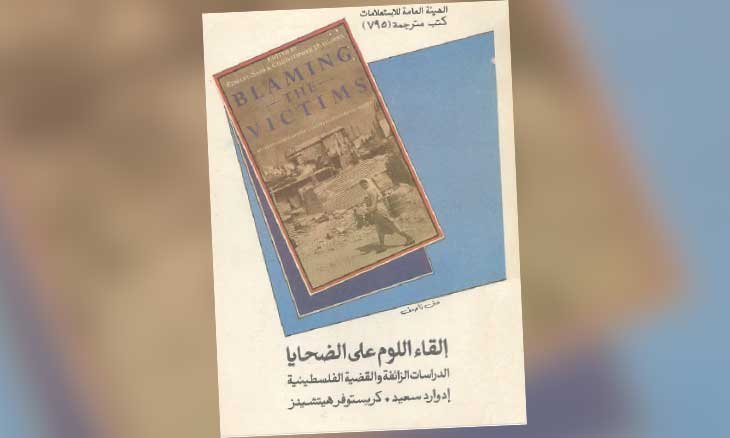شكلت محاولة احتكار مفهوم الضحية، جزءاً من الذهنية الصهيونية التي تسعى إلى التمركز على استعادة الهولوكوست ضمن استراتيجية تفيد من ممارسات إنشائية تجمع بين التشكيل الخطابي، وتأويل التأريخ؛ بما في ذلك تزييف الحقائق، وطمس الأدلة، والاجتزاء السياقي، فضلاً عن اعتماد مبدأ التكرار بهدف تكريس المعنى، والجملة الثقافية.
غايات ومقاصد
يمكن أن نطلع على صيغة من هذه الصيغ في كتاب «إلقاء اللوم على الضحايا – الدراسات الزائفة والقضية الفلسطينية» من إعداد إدوارد سعيد وكريستوفر هيتشينز، إذ ينطوي الكتاب على عدد من الفصول التي وضعها عدد من المفكرين، لبيان نماذج التزييف التي اضطلعت بها بعض الدراسات الغربية، بهدف إلقاء اللوم على الفلسطينيين، على الرغم من أنهم كانوا الضحية.
يمثل الكتاب محاولة لتقويض السرديتين الغربية والصهيونية، وكشف عوارهما في ما يتعلق باحتكار مفهوم الضحية، من أجل خدمة المشروع الصهيوني القائم على مبدأ يتمثل بسلب الأرض الفلسطينية، ونفي الصفات الوجودية والإنسانية عن الشعب الفلسطيني، ومن أجل تحقيق ذلك اشتغلت آلة خطابية كبيرة، وشديدة الاعتماد على مبدأ التعاضد من لدن الكتاب والمؤرخين الصهاينة، والغربيين، مع جملة من الانحرافات الإبستمولوجية. وبذلك يستهدف الكتاب استعادة التكوين العميق للشعب الفلسطيني على مستوى البنى الحضارية، ومن هنا فإن قيمة الكتاب تتأتى من كونه لا يسعى إلى خلق مروية مضادة فحسب، إنما يتجاوز ذلك إلى تكريس الوجود الفلسطيني بوصفه حقيقة واقعة.
انحرافات أكاديمية
من أبرز تلك الدراسات ما كتبه إدوارد سعيد في نقض كتاب جوان بيترز، بعنوان «منذ قديم الأزل: جذور الصراع العربي اليهودي على فلسطين». ففي هذا الكتاب مقولة جوهرية تستهدف بيان أن فلسطين أرض خالية لا وجود فيها لشعب، بمعنى الترويج للمقولة الصهيونية، عبر الإيهام باعتماد مبادئ علمية، حيث تدّعي الباحثة استدعاء أرشيفٍ وحقائق تاريخية وواقعية، ولكن المؤسف من وجهة نظر إدوارد سعيد، أن يلاقي هذا الكتاب ترحيباً ومراجعات وعروضاً كبيرة في الصحافة الغربية، ولاسيما من كبريات الصحف الأمريكية، في حين لم يتعرض الكتاب لنقد حقيقي، على الرغم مما فيه من تزييف سوى القليل جداً، وبناء على ذلك تندفع الحقائق المتوارية عبر نموذج علمي من أجل تعرية هذا التزييف الخطابي من لدن إدوارد سعيد، الذي يقدم قراءة وتحليلاً لا تنقصه الأسس العلمية والحقائق، ومن أهمها ما يتعلق بوجود العرب، أو الفلسطينيين على أرض فلسطين.
من أهم القضايا التي نقدها سعيد مقولة الباحثة، أن أرض فلسطين كانت شبه خالية، وأن سكانها وفدوا نتيجة هجرات عربية من دول المحيط، أو أنهم تم تهجيرهم بدواع ديموغرافية، وعلى ذلك فإن خطورة هذا الطرح ينهض على نفي أصالة الشعب الفلسطيني ووجوده، وهو ما يضطلع سعيد بتعريته، ونقضه بالحقائق، بما في ذلك الأرقام والإحصائيات، بالتوازي مع الاقتباسات المبتورة التي لجأت إليها الباحثة، كما نقد المبادئ الأرشيفية للكتاب، وأثر اللغة، ناهيك من النماذج التكرارية، التي اضطلعت بها مراجعات الكتاب من لدن الصحف الكبرى، أو بعض الكتّاب الغربيين المرموقين، الذين سعوا إلى تكريس مقولة، إنه كتاب مهم وقيم، لا لشي إلا لكونه يوافق المخططات الصهيونية، فلا جرم أن يجعل سعيد من عنوان مقاربته «مؤامرة الثناء» بداعي بيان زيف هذا الكتاب، مع محاولة استعادة قيمة الضحية، ونفي اللوم التاريخي عنها.
ولا يبتعد كثيرا فنكيلشتاين عن نهج سعيد، في نقد النماذج الخطابية الغربية الصهيونية، القائمة على مغالطات، ولاسيما ما يتعلق بتشويه المعلومات والقضية الفلسطينية في كتاب بيترز، وإذ يعيد مرة أخرى مركزية التهليل التي حظي بها الكتاب في الغرب، من ناحية خلو أرض فلسطين، ولذلك فإن بيترز ترى أن لليهود المهاجرين الحق في الأرض، يتجاوز حق الفلسطينيين الذين وفدوا مؤخراً على هذه الأرض، وهنا تكمن الأكذوبة على أشد ما تكون بما فيها من صلف وادعاء، فعلى الرغم من ادعاءات بيترز بعودتها إلى سجلات الأرشيف البريطاني، وبعض الدراسات التي قام بها مؤرخون صهاينة، غير أن فنكيلشتاين يذكر أن المعلومات التي اعتمدتها بيترز كانت انتقائية، في حين أن من صفقوا للكتاب لم يتكلفوا عناء مراجعة مصادره، وبذلك فنحن إزاء مخاتلة معرفية، عمّق وجودها ما يمكن نعته بالتصديق المؤسسي الذي قام به الغرب.
تزييف ممنهج
في الجزء الثاني إحالة واضحة من كريستوفر هيتشنز، بخصوص دور الإذاعة بوصفها جهازاً لتوليد يقين سريعٍ عبر القصّ والتكثيف؛ وخلاصة أمر، الادعاءات الصهيونية، أن العرب فروا من أرضهم لا بداعي التهديد الصهيوني، إنما بداعي قادتهم، وكان يتم ذلك عبر نداءات الإذاعات، أو بالتحديد أوامر عاجلة أذاعها رئيس اللجنة التنفيذية العربية العليا (المفتي)، في حين أن الحقيقة تخالف ذلك، فالعصابات الصهيونية كانت مسؤولة عن نزوح السكان، ولاسيما بقيادة بيجين وشامير، بالاعتماد على دراسة المؤرخ بيني موريس، لنلخص إلى أنه حوالي 72% من اللاجئين الفلسطينيين، تم طرهم بالقوة العسكرية الإسرائيلية، كما يؤكد الأرشيف التابع لجيش الدفاع. وعلى الرغم من ذلك، فمهما كان سبب الخروج، فثمة أمر ينبغي عدم إغفاله، ويتمثل بأن الفلسطينيين كانوا يتوقعون العودة بعد انتهاء الأحداث، وهذا ما لم يتحقق، فالعودة تبقى حقاً بغض النظر عن السياقات التي اتصلت بالحدث.
في محور بعنوان «الحقيقة التي تعيش بها الأمم» يشير الصحافي بيرتز كيدرون إلى واقعة توثيقيّة شهيرة، تتمثل بحجب جزءٍ من مذكّرات إسحاق رابين حول إخلاء اللد عام 1948، في حين أن سعي الصحافي لنشر ذلك، أحدث جدلاً قيمياً وأخلاقياً ذاتياً، ليصل في نهاية المطاف إلى خلاصة تتمثل بالأكذوبة التي تسعى بعض الأمم العيش معها، أو فيها.
حصرية الإرهاب
وفي نموذج آخر نقرأ محاولة من لدن نعومي تشومسكي، الذي ينطلق من أحداث تاريخية تتقصد بيان العوار الغربي في خلق نماذج من الازدواجية الشديدة، تجاه الانحياز الغربي للسردية الصهيونية، غير أن الأهم التعامي عن الإرهاب الصهيوني، ممثلاً بعمليات كثيرة منها قصف تونس، وممارسات في جنوب لبنان، وغيرها، الكثير، بحجة أن هذا يقع في تعريف أن العنف قد يكون أمناً، ولكن لصالح إسرائيل فقط. غير أن القيمة الأكبر تأثيراً النفوذ الذي تمارسه أمريكا في إفساد هذا العالم، من خلال ما تمتلكه من قوة تتجاوز النماذج العسكرية أو المادية، بمعنى الصيغ الخطابية، بما في ذلك الإعلام، وهي الصيغة التي يمكن أن نسقطها حالياً على ما يجري الآن في غزة، من ناحية نفي معنى الضحية عن أكثر من سبعين ألف جريح، ومئات الألوف من الضحايا، مع محاولة تحميل الفلسطيني مسؤولية كل شيء، وتجاهل كلي لأسس الصراع.
في جزئية «الاحتكار التعريفي» يذهب سعيد إلى نقد القيمة الاحتكارية لتعريف العنف والإرهاب ليكون لصيقاً بالآخر، لا الصهيوني، وهذا ينهض به صحافيون لديهم خلفيات غامضة، ويفتقرون إلى المقاييس العلمية، ولاسيما من ناحية التعميم والتجريد، فهم يعتمدون رؤية الصهيونية، التي ترى أن الإرهاب العربي الإسلامي يهدد الديمقراطية الغربية عبر استعادة مفضوحة لخطابات نتنياهو، ولاسيما كتابه «الإرهاب: كيف يحقّ للعالم الديمقراطي أن ينتصر» الذي يعدّ عملاً محورياً في تكريس هذا الادعاء، ونشره على نطاق واسع.
التنازع التاريخي
يستعيد إدوارد سعيد في جزء آخر كتاب «الخروج والثورة» لمايكل فالترز، الذي سعى من خلاله إلى العهد القديم بوصفه أداة للربط بين العالم الديني والعالم العلماني، وأثر ذلك على الكثير من المفكرين من ناحية محورية فكرة الخلاص، وفكرة الوقوف مع المستضعفين من اليهود كما يسعى الكتاب إلى بيان أن سفر الخروج لا ينهض على الصراع على الأرض، إنما على مبدأ أن الحق هو الأساس، مع محاولة نفي الأثر الكنعاني، وهكذا ينتقد سعيد «الخروج» ضمن سياقه اللاهوتي، كما يشير إلى التاريخ من ناحية توظيفه السياسي، مع تسمية الفاعل الاستعماري صراحة، ولكن بوصفه البديل الليبرالي. في الجزء الرابع ينهمك باور سوك في مساءلة فعل الكتابة، بما هو انتقال من التشارك التوراتي إلى التاريخ الاجتماعي، إذ يبرز كيف أسهم السرد اللاهوتي في حجب التشكلات الاجتماعية والسياسية في فلسطين، كما يكشف من ناحية أخرى عن نسق استبدالي يطمس البعد الواقعي لمصلحة خطاب لاهوتي يزعم امتلاك الحقيقة عبر استراتيجيات سلطوية، تتمثل بالحجب والطمس والتحييد، وبذلك يغدو التاريخ رهينة تأويل مشروعية حضارية كاذبة، غير أن هذا يفضي – حقيقة- إلى تلاعب سافر بالذاكرة الجمعية، كما يكشف عن آلية إقصائية راسخة في البنية الاستعمارية. في جزء آخر يقرأ أبو لغد القوميّة، بوصفها إطاراً تحرّرياً، وحقاً تاريخياً وسياقياً، حيث سعت الصهيونية إلى نفي البعد القومي في إطاره الوجودي. إذ كان يُشار إلى الفلسطينيين على أنهم عرب ينتمون إلى المنطقة المحيطة، مع دلالة سلبية تتمثل في التخلف، وأن الاستيطان الإسرائيلي سيقودهم إلى التحضر. ومن هنا فثمة ردة فعل تتمثل بالبحث عن قيم الوجود الفلسطيني، بدءاً من مشروع «ظاهر العمر» وما تلا ذلك من محاولات لتمكين النزعة القومية، بالتجاور مع جدل الصيغة المستقبلية للحياة أو التعايش ضمن بدائل متعددة. غير أنه يمكن قراءة هذا في السياق المعاصر، على أنه بات واضحاً أن التفكير اليهودي لا يحتمل سوى فكرة النبذ والإقصاء، بنزعة عنصرية فاضحة.
يسعى رشيد الخالدي في محور إلى اختبار مقاومة الفلاحين، ولا سيما قبل الحرب العالمية الأولى، إذ تنطلق هذه المقاومة من وعي عميق بقيمة الأرض، مع إشارات واضحة لا لبس فيها إلى أن الفلاحين كانوا جزءاً من حركة المقاومة، مع إيراد حقائق تاريخية، تشير إلى أن بعض العائلات اللبنانية هي من قامت ببيع الأراضي بالتعاون مع الدولة العثمانية، وهو تصحيح لحادثة تاريخية غالباً ما وُظفت بصورة مشوّهة، لينتهي إلى خلاصة مفادها أن مقاومة الفلاحين لم تكن هامشية أو معزولة عن مجمل الواقع الفلسطيني، إنما كانت جزءاً أساسياً من تاريخه، وواقعه.
في عمل أخير مشترك بعنوان «لمحة عن حياة الشعب الفلسطيني» ثمة قراءة لتموضع النموذج الحضاري في أرض فلسطين قبل قدوم القبائل العبرانية، بالتوازي مع بيان القيم الحضارية المتقدمة في التاريخ لهذا الوجود العربي، وازدهاره على أرض فلسطين، وكل ذلك من أجل نفي السردية الصهيونية التي عملت على تمزيق الوجود الفلسطيني وتفتيته. فلا غَرْو أن تذهب معظم الدراسات الغربية إلى التركيز على الحقبة اليهودية، وتناسي آلاف السنين من الوجود الآخر، أو الحقيقي، أو محاولة التقليل من أثره بعد أن أصبح لا مجال لنفيه بالمطلق، ولهذا يمكن تفهم ما سعى إليه هذا الجزء، من ناحية تتبّع الحضور الفلسطيني الحضاري منذ القدم إلى الآن عبر مصادر أرشيفية وإحصاءات لا يمكن إنكارها.
كاتب أردني فلسطيني